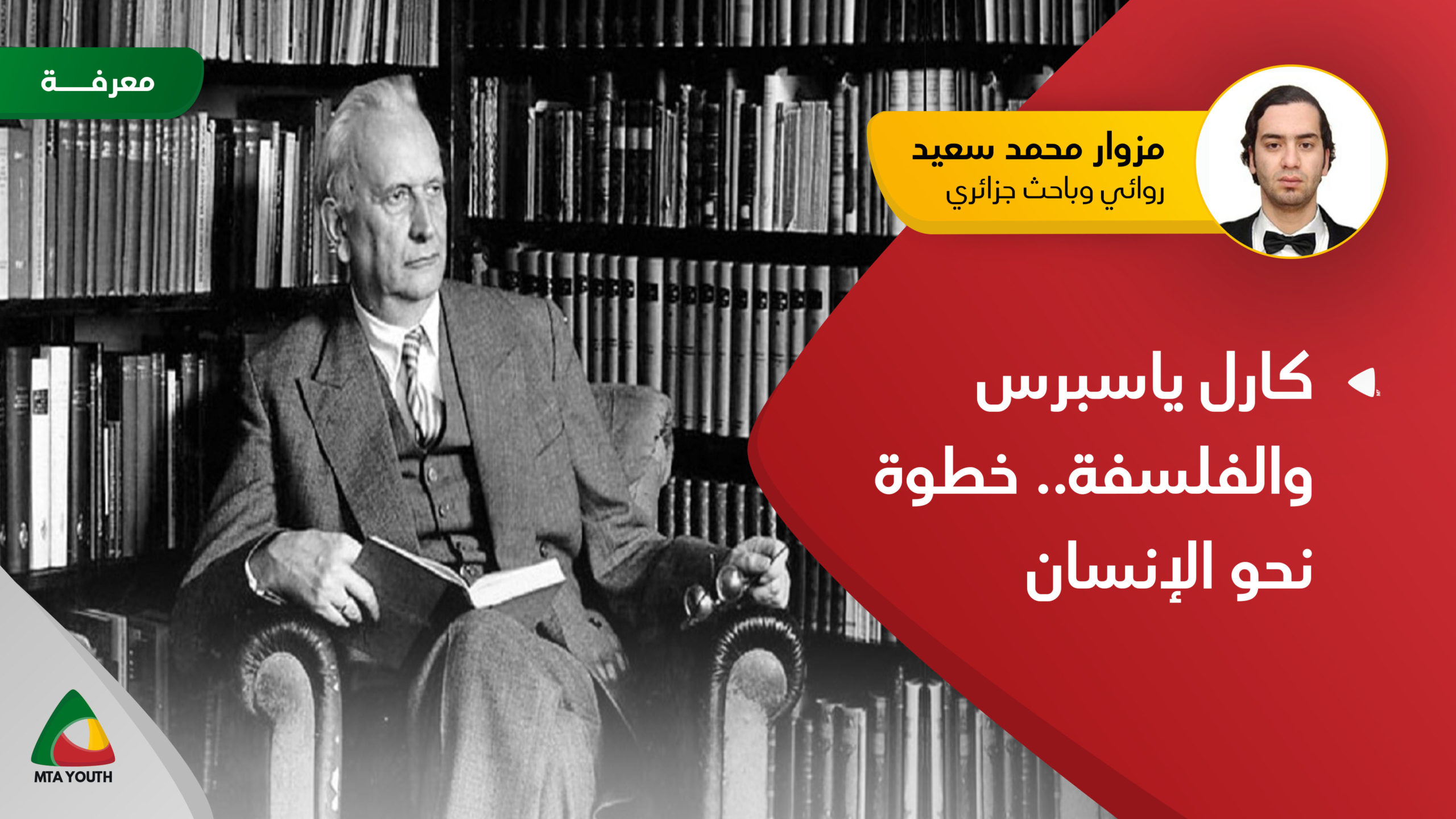
يقول الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس (1883-1969) في كتابه (مدخل إلى الفلسفة): “التفكير الفلسفي، وعلى خلاف العلوم، لا يبدو أنّه يتقدّم، إنّنا نعرف حقا أكثر ممّا كان يعرف أبقراط، ولكن ليس بوسعنا أن نزعم أنّنا تجاوزنا أفلاطون، إنّ محصوله العلمي فقط كان أقلّ ممّا لدينا، أمّا ما لديه من بحث فلسفي بكلّ ما في الكلمة مِن معنى، فلعلّنا كدنا نلحق به”.
لقد ارتبط البحث الاجتماعي عبر العصور، خاصة لدى أبناء الحضارات والامبراطوريات المختلفة، بما يحمله الفرد في وعائه الواعي مِن تفكير وأفكار.
وبذلك سادَ المفكرون على كافة الأصعدة، وعلى اختلاف الثقافات، وهذا ما جعلهم يتحكّمون في مصير الشعوب على تنوّعها.
باسطين سيطرتهم بواسطة العقل على كافة الجوارح الاجتماعية الأخرى وفق قوانين المنطق تارة، التفلسف أغلب الأحيان وما وصلته التكنولوجيا على اختلاف مراحلها تارة أخرى.
وفي أثناء قيام المفكّرين والفلاسفة بلعبتهم المفضلة، ألا وهي صناعة الأحداث العظيمة وكتابة تاريخ انتصاراتهم على الأيّام والإنسان معا، ظهر على حين غفلة منهم، وبتواطؤ بارز من بعضهم سؤال:
لماذا يفسّر الناس جوانية الفلسفة عبر طرائق متعدّدة؟
وأين تتشابه الفلسفة مع العلوم التي تدير الحياة المعاصرة؟
وكيف يؤرّخ كارل ياسبرس لهذه الإشكالية “ارتباط العلوم بالفلسفة ضمن الحياة”؟
كلّ إنسان يولد ليرقد في المهد الفلسفي، بينما يكمن الفرق بين البشر في كيفية التعامل وطريقة العناية بهذا المكان الوجودي الأوّل، فهناك مَن يبقيه دافئا ناعما لبقية حياته، يحرسه بنور البصيرة، وبجنود تتميَّزُ بأبصار القطف واللقف، وهناك مَن يحرق هذا المهد بيديْه كما يفعل الفرد الجزائري، ليبقى مشرّد الفكر وهائم التفكير، إن فكّر أصلا، وَلطيلة حياته.
لقد أظهر الفلاسفة الألمان قدرة غير معقولة وهائلة للغاية في البحث عن مشروعية الفلسفة وشرعيتها في حياة الإنسان منطلقين من إنسانيته، وهذه علامة تُحسب لهُم جملة وتفصيلا.
ومِن بين هؤلاء نجد كارل ياسبرس، الذي أظهر الفرق جليّا ما بين العلوم والفلسفة من جهة، ومدى قيمة التفكير الفلسفي أو التفلسف من جهة أخرى.
إذ يرى كارل ياسبرس بأنّ الفلسفة كقيمة لا تزال محط نقاش مستمر، وإن ما حاولتُ الوصول إلى حصر الآراء المنتشرة للغاية في قوالب تقترب من الضبط، يمكنني الاعتماد على ثلاثة مجموعات واضحة التباين:
- الأولى: ترى في الفلسفة ضرورة تغوص في الصميم الوجودي للبشر وبني الإنسان وحتى أبناء آدم كلّهم دون تمييز.
- الثانية: تقدّر المجهود الذي بذله الفلاسفة عبر العصور، رغم اعترافها بصعوبة هضم وفهم كافة الأفكار التي رشحت عن عقول هؤلاء العباقرة.
- الثالثة: تمسح كل فضل إلى الفلسفة والفلاسفة وتتنكّر لهم، مرجحة أنّ التفكير الفلسفي مادة عقيمة ليس هناك سبب يجعلها موجودة وحاضرة، فهي لا تتجاوز كونها فضاء للحالمين والمشككين فقط.
هناك أيضا بين هذه الأمواج الثلاثة من التصوّرات، نجد الفلسفة كالهاوية التي تبلعُ جميع التجلّيات، وتطلب المزيد، مستوعبة كلّ فكرة غير مبالية بجنسها، تأثيرها وحتى مصدرها، بل إنّها لا تلتفت إليها في حدّ ذاتها سوى كفكرة يجب استهلاكها.
هذه الشراهة التي تتميّز بها الفلسفة هي القوّة الوجودية المستمرة، والتي تجعل منها أزلية وسرمدية، بحيث توفّر لها الفرصة التي لا يجدها الإنسان المتأمّل لدى غيرها، فتعطيها الحق والقدرة على منافسة حتى ذاك الوحش، والذي يسميه الجميع بـ: الدين، فهي تحمل الكثير من سماته وخصائصه المتعالية، في حين أنّها تتغذى على قداسته، نافضة عن ثوبها الأثيني تلك القداسة المنافقة.
نتائج الفلسفة ليست قطعية كما هو الحال في العلوم، وهذا ما يجعلها وحشا سريع المناورة ذهنيا وعمليا، ومِن هذه الخاصية الفريدة أنجبت الفلسفة للإنسانية ذلك الذي نسميه في عصرنا المعاصر بـ: التفكير النقدي، معطية جرعة حياة إضافية إلى ذاتها الضاربة في حقول الإغريق، والممتدة وصولا إلى بحر الصين الجنوبي، لتلتهم العالَم بأسره بعدها كما فعل وحش هيدرا يوما ما.